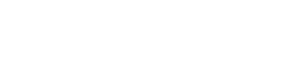الاهتمام بعلاج مرض القلوب والإصرار على المعاصي

عناصر الخطبة
1/ القلب أمير الجوارح 2/ على العبد الاهتمام بعلاج مرض قلبه قبل مرض بدنه 3/ لماذا كان مرض القلب أشد من مرض البدن؟! 4/ العاقبة الدنيوية للذنوب والمعاصي 5/ الإصرار على المعاصي وكيفية علاجه 6/ طول الأمل والتسويف وأثرهما على القلب
اقتباس
ولما كان القلب بالنسبة لأعضاء الإنسان كالملك المتصرف في الجنود، الذي تصدر كلها عن أمره وتنشطها وتتحرك لها، وتنكر وتصالح لنهيه، فكلها تحت عبوديته، كان الاهتمام بتصحيحه وتنظيفه أَوْلى ما انشغل به السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله..
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70، 71].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أيها المسلمون: يقول الله -عز وجل-: (أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) [القيامة:36]، ويقول -عز وجل-: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) [المؤمنون: 115، 116]، وإنما خلقهم ليأمرهم وينهاهم، وقسمهم إلى عاصٍ شقي، وطائع سعيد، وجعل لكل من الفريقين منزلاً فقال تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلا لأَجَلٍ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) [هود: 103-108].
وقد أعطى الله العباد مواد وآلات العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح، فمن استعمل ذلك في طاعته، فقد سلك به إلى رضاء ربه سبيلاً، ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فقد خسر خسرانًا مبينًا، وسيحزن حزنًا طويلاً، وسيندم ندمًا بليغًا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، حيث الحساب على حق هذه الأعضاء: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) [الإسراء: 36].
(وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ * فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) [فصلت: 19-24].
ولما كان القلب بالنسبة لأعضاء الإنسان كالملك المتصرف في الجنود، الذي تصدر كلها عن أمره وتنشطها وتتحرك لها، وتنكر وتصالح لنهيه، فكلها تحت عبوديته، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فلما كان أمر القلب كذلك، كان الاهتمام بتصحيحه وتنظيفه أَوْلى ما انشغل به السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون.
فحق على العبد أن يهتم بعلاج مرض قلبه قبل مرض بدنه، وما أكثر أمراض القلوب وما أشدها، فمرض القلوب أكثر وأشد من مرض الأبدان، وإنما صار مرض القلوب أشد من مرض الأبدان لثلاثة أسباب:
السبب الأول: أن المريض لا يدري أنه مريض، ومن ثم فإنه لا يهتم بعلاج نفسه، فيستفحل فيه المرض حتى يهلكه.
السبب الثاني: أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم -ونعني بها العقوبة الأخروية- بخلاف مرض الأبدان، فإن عاقبته موت مشاهد ينفر الطبع منه، أما بعد الموت من عاقبة الذنوب وأمراض القلوب فهو غير مشاهد، فقلّت النفرة من الذنوب وإن علمها مرتكبها، فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب ولكنه يجتهد في علاج البدن من غير اتكال.
هذا مع أن للذنوب وأمراض القلوب عاقبة مشاهدة في الدنيا من الآثار الرادعة التي يردع الله بها أصحاب المعاصي في الدنيا، ولكن مع الأسف لا يقتنع العصاة -أفرادًا ومجتمعات- أن هذه العقوبات التي يعاقبهم الله بها في الدنيا هي سبب معاصيهم، وإذا قلت لهم: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) [الشورى:30]، اشمأزت قلوبهم، وصوبوا إليك نظرات احتقار حانقة، ولسان حالهم يقول: ماذا يقول ذلك الغبي الساذج؟! أي علاقة لما يصيب العبد أو المجتمع من شقاء بالذنوب والمعاصي؟! ماذا يقول ذلك الرجل المتخلف؟!
فإذا ما أردت أن تعرف منهم الأسباب الوجيهة والتحليلات العلمية العميقة الذكية لما هم فيه من بلاء قالوا: إن ذلك بسبب تغير القوى الاقتصادية، أو بسبب الانفجار السكاني، وأمثال هذه وتلك من الأسباب، أما أن تقول: الذنوب والمعاصي، فتلك هي الرجعية المضحكة، فبالأهل الكبر والطغيان، أمرهم كبر والعياذ بالله: (وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلا طُغْيَانًا كَبِيرًا) [الإسراء:60]، (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) [المؤمنون: 76]، ماتت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، يطبع الله عليها بكبرهم، فقليلاً ما يؤمنون: (تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ * وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) [الأعراف: 101، 102].
أين هم من دعوة نوح لقومه؛ إذ يقول لهم: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) [نوح: 10ـ12]؟! أم أين هم من قول هود لقومه: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) [هود: 52]؟! وأين هم من قوله تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) [طه: 124]؟! وقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [الأعراف:96]؟!
والذي نريد أن نصل إليه بعد هذا الاستطراد: أن من الأسباب التي تجعل مرض القلوب أشد خطورة من مرض الأبدان أن عاقبة مرض القلوب الأخروية غير مشاهدة في الدنيا، وعاقبتها الدنيوية لا يتصور مريض القلب نظرًا لانطماس نور قلبه أنها سبب معاصيه، فهي غير مشاهدة له كذلك، ولو كان له بصيرة لكان حاله كحال السلف الصالح؛ إذ يقول أحدهم: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. وكون مريض القلب لا يرى عاقبة مرضه، هو الذي يجعله لا يبالي بمرضه ولا يخاف منه، فيتمادى في الإعراض عن العلاج، فيزداد مرضًا على مرض.
أما السبب الثالث الذي يجعل مرض القلوب أشد وأخطر من مرض الأبدان: فهو فقد الطبيب الذي يعالج هذه الأمراض، وهو الداء العضال، والأمر المؤلم المحزن، فإن أطباء أمراض القلوب هم العلماء، وهم قد مرضوا مرضًا شديدًا في هذه الأعصار -إلا من رحم الله منهم وثبتهم-؛ لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب هذا الداء على الأطباء، فماذا يصلح الملحَ إذا الملحُ فسد؟! لهذا السبب الأخير عمّ الداء وانقطع الدواء، وقد أصاب سلفنا الصالح حين قالوا: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. أي لولا العلماء أوجدهم الله لعاش الناس كالبهائم، وهو ما آل إليه حالهم اليوم لمَّا مرض العلماء.
الأرض تحيا إذا ما عـاش عالمهـا *** متى يمت عالم يومًا يمت طرف
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حلَّ بها *** وإن أبى عاد في أكنافها التلف
فتلك ثلاثة أسباب من أجلها صار مرض القلوب أشد وأخطر من مرض الأبدان، وفيما تبقى لنا من دقائق نشير إلى مرض منتشر جدًّا من أمراض القلوب، ألا وهو الإصرار على الأمر القبيح، سواء أكان منكرًا محرمًا أم طبعًا رديئًا، أم تصرفًا قاصرًا، أم عادة سيئة، أم سلوكًا ملتويًّا، وليس مقلقًا أن يقع العبد في معصية أو خطأ؛ فكل بني آدم خطاء، والعالِم والجاهل كلاهما غير معصوم من الوقوع في الذنب، ولكن المقلق المخوف في الدنيا والآخرة الإصرار على المعصية، والإصرار على الخطأ، والإصرار على العادة السيئة، والإصرار على الطبع الرديء، والإصرار على أي قبيح.
أما من يقع في الخطأ فيتوب التوبة النصوح ولا يصر فهو خارج عن هذا المرض؛ مرض الإصرار، الإصرار الذي قد يتصور صاحبه أنه على صواب ويأخذه الغرور، الإصرار الذي يريد صاحبه أن يتغير الناس من حوله ولا يتغير، أو الإصرار الذي يصرح صاحبه أنه على خطأ أو معصية ثم لا يبالي بتغيير نفسه، وقد يتذرع بحجج تافهة حقيرة، فربما قال: لو فعل فلان كذا سأترك الذنب أو المعصية، فعجبًا كيف يربط إقلاعه عن المعصية وعلاجه لمرضه بأمور لن تنفعه أمام الله -عز وجل-؟! وتأخذه العزة بالإثم فيقول: أنا أفعل هذا الخطأ عمدًا في فلان، أو يقول: يعفو الله عنا، ويسوّف.
وإذا ما نظرنا إلى مرض الإصرار على القبائح من نافذة أمراض القلوب وخطورتها لوجدنا ما ينطبق على أمراض القلوب من أسباب الخطورة ينطبق عليه، ولذلك لزم في علاج هذا المرض تبيين خطورته كمرض من أمراض القلوب، وتوضيح أسباب هذه الخطورة والتحذير منها حتى يهتم العبد بالعلاج، ويستشعر ضرورة إجبار نفسه عليه، فيجب أن يعرف العبد أنه إن كان متشككًا في مرضه فليعلم أن ذلك لا ينفي عنه المرض؛ لأن مريض القلب قد لا يدري أنه مريض، ولكن الطبيب الحاذق الثقة هو الذي يلاحظ مرضه، فعليه بطاعته، وعليه أن يحمد الله أن أطلعه على مرض نفسه ليعالجه قبل أن يهلكه. فهذه أول رحلة من رحلات العلاج: أن يعرف المريض أنه مريض، فيبادر إلى العلاج.
فإذا عرف المريض أنه مريض فلم يبادر بالعلاج فربما كان ذلك لتصوره أن مرضه لا خطر منه؛ لأنه ليست له عواقب وخيمة، فهذا يلزم أن يعرف العواقب الوخيمة لمرضه إن لم يعالجه ويخوف نفسه بها ويتذكرها، أو يخوفه غيره بها ويذكره بها دائمًا؛ حتى لا يهنأ له عيش إلا بعد أن يعالج هذا المرض.
وهنا قد يقول قائل: بعض الناس يعلم مرض نفسه وقبح عواقبه، ومع ذلك فهو مستمر مقيم على الذنب. فهذا واقع بلا شك، ولذلك أسباب: منها أن العقاب الموعود ليس بحاضر كما سبق أن ذكرنا، ومنها أن المؤمن وعد أن التوبة تجبر ما فعل، ولكن طول الأمل غالب على الطباع، فلا يزال يسوّف بالتوبة، ومنها أنه يرجو عفو الله عنه.
وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ما هو آتٍ قريب، وأنه لا يأمن هجوم الموت، ويعالج التسويف بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف، والمسوّف يبني الأمر على ما ليس إليه، وهو البقاء وامتداد الحياة، فلعله لا يبقى، وإن بقي فربما لم يقدر على ترك الأمر المذموم غدًا كما يقدر عليه اليوم، وهل عجز عن الترك اليوم إلا لغلبة الشهوة، والشهوة غير مفارقة له غدًا، بل سيتأكد سوء حاله بالاعتياد، ومن هذا هلك المسوفون؛ لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين، فيظنون أن التوبة سهلة في الغد وصعبة اليوم، وما مثال المسوِّف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه، فالعجب من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها، كيف ينتظر الغلبة إذا ضعف هو وقويت هي؟!
وهكذا حال صاحب المعصية أو الصفة المذمومة الذي يسوِّف وتستحكم فيه مع مرور الوقت، فتصبح التوبة والإقلاع عنها أصعب. وأما انتظار عفو الله تعالى، فعفو الله ممكن إلا أن الإنسان ينبغي له الأخذ بالحزم، وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلها، وترك نفسه وعياله فقراء، ينتظر من الله أن يرزقه العثور على كنز في خربة، وهذا ممكن، إلا أن صاحبه يلقب بالأحمق. والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أحمده -سبحانه- وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، حَمى حِمى التوحيد، وسدَّ كل طريق يوصل إلى الشرك، فأظهر الله به دينه على الدين كله، ولو كره المشركون.. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
أيها المسلمون: يجب على المصاب بمرض الإصرار على الأمر القبيح أن لا يسوِّف، بل يسارع بهمة إلى العلاج وتناول الدواء، وهو مركب من علم وصبر، وإن سبب الإصرار الغفلة والشهوة، والشيء لا يبطل إلا بضده، ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة.
فعليك بالعلم والصبر لتشفى من مرض الإصرار، ومن العلم النافع في ذلك أن تقرأ القرآن، مع التركيز على استخراج الآيات التي فيها تخويف للمذنبين، وتتصور كل عذاب أشار إليه القرآن على أنه واقع عليك، وتتخيل نفسك من أولئك المعذبين، فحينئذ ستدرك أنه لا طاقة لك ولا صبر على ذلك، فتنزعج عن المضي في المعاصي، وتعزم على الإقلاع عنها، كما تبحث عن ذلك في الأحاديث والآثار أيضًا، كذلك التمس الآيات والأحاديث في مدح التائبين؛ حتى تتشوق للتوبة والتلذذ بحلاوتها، والتمس الحكايات التي فيها بيان نصيب الخلق من المصائب لمخالفة واحدة ويعفو الله فيها، كحال آدم -عليه السلام- مثلاً وما لقيه من الإخراج من الجنة بسبب أكلة أكلها من شجرة نهاه الله عن الأكل منها، وتفكر كذلك في قضاء الله على إبليس بالخروج من الجنة والخلود في النار لاستكباره عن أمر الله بالسجود لآدم.
وإن كنت ممن لم تصبهم مصيبة في الدنيا جزاءً على معاصيهم، فلا تغتر بذلك، فربما عجل الله العقوبة في الدنيا لمن يريد له أن يتذكر، فيسلك طريق السعادة، ويهوَّن عليه من عذاب الآخرة، وفي المقابل قد يترك الله من كتب عليهم الشقاوة بلا مصائب إمهالاً لهم ليزدادوا إثمًا، ويبقي لهم عذاب الآخرة وافرًا، فهو أشد، فخوف نفسك مرة من عقوبات الدنيا ومرة من عذاب الآخرة، وحاول أن تثير في نفسك بغض الإصرار على المعصية، والحنق عليها، ومعاداتها بتذكر أثرها السيئ على العقل والقلب والنفس، فالإصرار على معصية من المعاصي يسبب ظلمة في القلب، وتعبًا في النفس، وشرودًا وتشتتًا في العقل والفكر، وضياعًا للبصيرة والفراسة، بينما ينال العبد بعد الإقلاع عن الذنب راحة في النفس، ونورًا في القلب، وقوة ونورًا في العقل، وبصيرة نافذة في الأمور، وفراسة قوية، وصفاءً في الذهن، وتدبر -إلى جانب ذلك كله- ما درأ من حدود وعقوبات على بعض المعاصي كالرجم والجلد وغيرهما، فتصوُّر الإنسان نفسه مستحقًا لذلك -إن ارتكب الذنب- يكسر نفسه، ويشعرها ببشاعة معصيتها.
ثم لابد من الصبر على ترك المعصية، وعلى ترك أي قبيح تريد التخلص منه، وعلى ترك الأسباب الموصلة إليه، وعلى تناول العلاج المضاد، وإلا طال المرض عليك، واستحكم فيك، فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنما يحمله على ذلك شدة شهوته، أو غفلته عن مضرته، فلابد من مرارة الصبر، وكذلك تعالج الشهوة إلى المعاصي بالصبر على مرارة العلاج، وقطع الأسباب الموصلة إليها. فإن كان سبب إصرارك على المعصية وجودك بين أشخاص معينين يحملونك عليها ويهيئون لك السبيل إليها، فاصبر عن الابتعاد عنهم، وإن كان سبب إصرارك على المعصية وجودك في بقعة أو مكان معين، فعليك بالصبر على عدم مقاربتها، وإن كان سبب إصرارك على المعصية تفكرك فيها، وتذكرك لها، وعيشك متفردًا، فاصبر على العلاج المضاد، وهو أن لا تنفرد وحدك، فالعلاج دائمًا يكون بالضد لمن أراد بصدق وعزيمة أن يتخلص من مرضه.
ومن المعاصي ما تستطيع أن تقلع عنه دون رجعة بعد أن تغير بيئتك إلى بيئة مضادة، ولو لفترة قصيرة من الزمان، تلجئ نفسك فيها إلى وضع وظروف يصعب فيها فعل المعصية، فعلى سبيل المثال: لو أردت أن تتخلص من عادة سيئة كالتدخين مثلاً فاعتكف عشرة أيام مع بعض أهل الصلاح والطاعة، تدخل معهم الاعتكاف، ليس معك شيء من الدخان، فإن أتممت معهم الأيام العشرة على ذلك فذلك كافٍ للتخلص من مرضك.
ويجب أن نقول: إن من أهم الأسباب المهيجة للشهوة حضور الشيء المشتهى، أو التفكر فيه، أو النظر إليه، أو الاقتراب منه، فلذلك كان من أهم الأسباب القاطعة للشهوة الابتعاد عن المشتهى المحرم، الابتعاد عنه ببصرك وبتفكيرك وببدنك، واللوذ بالصحبة الخيرة المذكِّرة بالله والآخرة، والتردد على مجالس العلم، والإكثار من مذاكرة العلوم الشرعية، فكل ذلك مما يضعف ويوهن الشهوة إلى المعاصي والتفكير فيها.
ومما ينفعك كذلك في الصبر عن المعاصي أن تجالس التائبين فور توبتهم، فإن مجالسة التائب حديث التوبة ترقق القلب، وعليك أن تستفيد منهم بمعرفة حالهم، وكيف احتقروا الشهوات واستطاعوا التخلص من المعصية، وماذا وجدوا من لذة بعد التوبة، وماذا عرفوا من بؤسهم حين كانوا قائمين على معاصيهم وشهواتهم، وماذا تفتح لهم من آفاق سعيدة بعد الإقلاع عن المعصية، فإنهم فور توبتهم يكونون شديدي الإدراك لحقارة المعصية وجمال الطاعة وسهولة التحول من هذه إلى تلك، فلعلك تتشجع وتنشط باستماعك إلى تجربتهم العملية الواقعية، فيذهب عنك اليأس، وتكسر طوق الإصرار، وتنطلق من غل المعصية إلى رحاب الطاعة، والله المستعان وعليه التكلان.
فانشط –أيها المسلم- في تغيير نفسك، ولا تألف ما أنت عليه، فتستنيم لما فيك من أخطاء حتى تظنها -بمرور الزمن- صوابًا وحسنًا، ولا داعي للغرور أو التكاسل والتسويف، فإن أمامك فتنًا وأهوالاً، وأمورًا عظامًا، وحياة وأحداثًا ضخامًا، من بعد هذه الحياة مما يكون في الموت المؤلم المجهز على الآمال والتسويفات، ثم ما يكون بعده في القبر من فتنة وعذاب، حين يمتحن الناس في قبورهم، حيث يقال للعبد: من ربك؟! وما دينك؟! ومن نبيك؟! فحينئذ يثبت الله أهل الإيمان، فينطقون بالحق والصواب، ويضل أهل الفسق والارتياب، فيمارون ولا يهتدون للجواب، فتعاجلهم مرزبة من حديد، تضربهم ضربة يصيحون منها حتى يسمعها كل شيء إلا الإنسان؛ إذ لو سمعها لصعق وما استطاع من قيام، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح في الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في الكتاب، وعلى لسان خير الأنام، وأجمع عليها أهل الإسلام، فيقوم الناس من الأجداث أحياءً، فيقول أهل الكفر والنفاق: (يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا)، ويقول أهل اليقين والإيمان: (هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ) [يس: 52]، فيقومون جميعًا من قبورهم لرب العالمين، حفاة عراة غير مختونين، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويلجمهم العرق وتغشاهم الكروب، وتنصب الموازين، فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
تنصب الموازين فتوزن أعمال العباد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره، تنصب الموازين فلا تظلم نفس شيئًا، وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وتنشر الدواوين -وهي صحائف الأعمال- فآخذٌ بيمينه، وآخذ بشماله أو من وراء ظهره، (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) [الإسراء: 13، 14]، (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا) [الانشقاق:7-12]، (فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ) [الحاقة: 25، 26]، (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) [الكهف:49].
وبينما يكون الناس في العطش الأليم والحر الشديد والكرب العظيم، إذا بالمؤمنين يرون حوض المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وإذا ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا، ثم يأتي الخلق جميعًا إلى الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، وهو جسر بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوًا، ومنهم من يمشي مشيًا، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يُخطف خطفًا، ويلقى في جهنم حيث الحميم واللظى والسعير، والصراخ والعويل، والزقوم والغسلين.. اللهم أعذنا من شرها، واجعلنا ممن لا يمسون حسيسها.
وأما من مرَّ على الصراط إلى آخره فإنه يدخل الجنة حيث العيش الهنيء، والنظر إلى وجه الرحمن الكريم الرحيم، واللهو مع الحور العين، والفراش الوثير، والرضا والسرور، والفرح والحبور، لكن قبل أن يدخل أهل الجنةِ الجنةَ يقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هُذِّبوا أو نُقُّوا أذن لهم في دخول الجنة..
اللهم اجعلنا من أهلها الذين تمن عليهم بدخولها، وأعنا على الأخذ بالأسباب إلى وصولها، اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان، وحبب إلينا الإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم تب على التائبين، واعف عن العصاة المذنبين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.